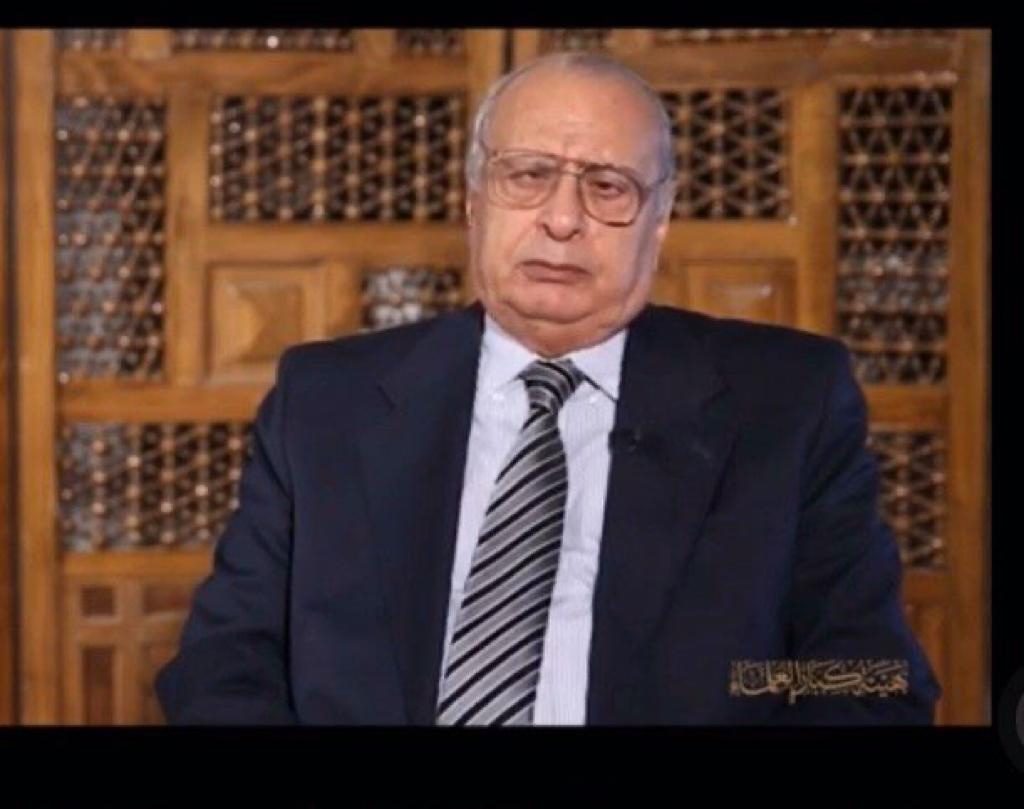يختلف مفهوم توحيد الألوهية عن معنى التوحيد الذى تكلم عنه علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية.
ذلك أن المتكلمين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام:
1-توحيد الذات: بمعنى أنه سبحانه واحد فى ذاته فلا قسيم له.
2-توحيد الصفات: بمعنى أنه واحد فى صفاته فلا شبيه له.
3-توحيد الأفعال: بمعنى أنه واحد فى أفعاله فلا شريك له.
واستدل المتكلمون على كل نوع من هذه الأنواع بأدلة كثيرة تطلب فى مكانها من علم الكلام.
أما توحيد الألوهية: فمعناه الإيمان بأن يعبد الله وحده لا يشرك بعبادته أحدا، وهذا يقتضى من المؤمن الإخلاص لله، والإحسان، وامتلاء القلب بالله حبًا، وتعبدًا، وإنابة، وتوكلاً وقصدًا، ودعاءً، واستعانةً، فإذا سأل فلا يسأل إلا الله، وإذا استعان فبالله، وإذا افتقر فإلى الله، وإذا اتسع قلبه لغير الله أو أحب غير الله؛ فينبغى أن يكون ذلك من أجل الله وليس لغيره، فلا يحب شيئًا غير الله لذاته، وإنما يحبه لما فيه لله، لما يقربه إلى الله تحقيقيًا لقوله تعالى فى الحديث القدسى: «أصدق الإيمان إذا أحب المرء أن يحب لله، وإذا كره أن يكره لله»( ).
ويتحقق ذلك بأن تكون مرادات العبد موافقة لمرادات الله فلا يريد إلا ما يريده الله، ولا يحب إلا ما يحبه الله رسوله، ولا يوالى أو يعادى إلا من أجل الله، وبهذا يتحقق معنى قول المسلم لا إله الا الله كما قال تعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كانت مرادات النفس موافقة لمرادات الله سبحانه وتعالى؛ فلا تريد إلا ما يريد الله، فقد تحقق معنى العبودية المطلقة التى يتحقق بها معنى الألوهية، ومن طبائع النفوس أنها تحتاج إلى من تثق فيه وتعتمد عليه فى تحقيق مطالبها، فتستعين به على قضاء حوائجها، وتفزع إليه عند النوائب وعند نزول المصائب، وهذا عام فى كل بنى آدم، ولا شك أن ما تستعين به النفس تخضع له وتزل له وتتقرب إليه بما يحبه ويريده، فيكون المستعان به هو المعبود الذى تواليه النفس محبةً وإنابةً وتوكلاً عليه، وكثيرًا ما تتلازم العبادة والاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب فى رزقه ونفعه وضره خضع له لأنه استشعر فيه القدرة عى تحقيق مطلوبه، فإذا علم العبد أن العبد لا يملك له من ذلك شيئًا وإن ظن أنه يقصده ليعينه على تحقيق مطلوبه فيكون قصد الوسائل؛ وليس قصد الغايات، والمقاصد لأن العباد وسائل لتحقيق اقدار الله فى العباد.
أما الذى ينبغى أن يقصد لذاته والذى تألهه القلوب لذاته فلا يكون إلا الله لأنه الصمد الذى يحتاج إليه كل ما سواه، ولا يحتاج هو إلى غيره لأنه الغنى المطلق؛ ولهذا جمعت الصلاة فى كل ركعة منها بين الأمر بالعبادة والأمر بالاستعانة على سبيل الدعاء والاقرار معًا قال تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) (الفاتحة:5) ويقتضى توحيد الألوهية ألا يعلق العبد رجاءه بغير الله كما قال تعالى: (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته) (الزمر:38)، وهذا النوع من التوحيد هو قطب رحى الإيمان، وذروة التقرب لله لأن توجه القلوب لغير الله طلبًا ومسالةً ورجاءً مذلة للعبد؛ لأن العبد لا يملك للعبد نفعًا ولا ضرًا ولا عطاءً ولا منعًا إلا بإذن الله، كما قال تعالى: (إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه)(الإسراء:67).
ذلك أن الإله هو الذى يُؤَلَهُ فيعبد دون غيره، ويُطْلَبُ دون غيره، ويُسْأَلُ دون غيره محبةً وإنابةً وإجلالاً وإكرامًا، وتوحيد الألوهية يتضمن أن القلب يتوله حبًا فى الله( ). والقلب يألهه فيعبده وحده، ولفظ الإله يعنى الذى جبل القلوب على محبته وولِهَ القلبُ حبًا فيه،فهو من: وله يوله إذا والاه بالمحبة، وهذه كلها من معانى الألوهية.
وتوحيد الألوهية هو دعوة جميع الرسل، وهو النداء الذى كان يتوجه به كل رسول إلى قومه فيقول لهم: (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) (هود:50) قالها جميع الأنبياء والرسل، ولا يتحقق إيمان المرء إلا به.
واستدل علماء العقيدة على توحيد الألوهية بأدلة كثيرة من القرآن الكريم، قال تعالى لرسوله الكريم: (فاعلم أنه لا إلا الله واستغفر لذنبك)(محمد:19). وقال تعالى: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) (المؤمنون:91). وقال تعالى: (قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) (سبأ:22-23).
فالآية توضح لكل من عبد غير الله ولكل من أشرك فى العبادة مع الله، أن أسباب العبادة، لغير الله منفية لأن الذين تعبدونهم من دون الله لم يخلقوا شيئًا يستحقون عليه العبادة ولم يشاركوا فى الخلق، ولم يعاونوا الخالق، ولن يشفعوا لأحد عند الله إلا بإذن الله، فلماذا تعبدونهم إذن؟
أما توحيد الربوبية: فمعناه الإيمان بأن خالق العالم، واحد وهو مشتق من الربوبية بمعنى التعهد بالتربية والحفظ والقيومية على المخلوق.
ويرى علماء العقيدة أن هذا النوع من التوحيد قد جُبلت عليه الفطرة السليمة، وأقرت به العقول السوية؛ فلم تُنْكِرُهُ الفطرة، قد اعترف به المشركون كما سجل ذلك القرآن الكريم فى أكثر من آية قال تعالى: (ولن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) (الزمر:38).
ولذلك كانت دعوة جميع الأنبياء إلى إخلاص العبادة لله ولا نشرك مع الله أحدًا فى العبادة، والشرك الذى وقع على الأرض، وواجهه الأنبياء لم يكن شركًا فى معنى الربوبية؛ لأنهم قد أقروا بأن الخالق هو الله، ولكنهم مع إقرارهم بأن الله هو الخالق عبدوا غيره أو أشركوا معه غيره فى العبادة، فجاءت دعوة الرسل تدعوهم إلى رفع هذا الخلل الواقع فى الإيمان فما داموا يقرون بأن الله هو الخالق – وحده-فلماذا عبدوا غيره!؟ ولماذا اشركوا غيره فى العبادة؟. وهذا هو جوهر الشرك الحاصل على الأرض. ولذلك تجسدت دعوة الرسل جميعًا فى هذا النداء ياقومى أعبدوا الله مالكم من إله غيره.
ومن الحاصل أن الإقرار بتوحيد الإلوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية؛ لأن كل من أخلص العبادة لله وحده قد آمن به ربًا خالقًا، وإلهًا معبودًا، وليس كل من أقر بأن الله هو الخالق قد أخلص العبادة لله وحده بل قد عبد غير الله أو أشرك مع الله فى العبادة غيره .
وكل توحيد للألوهية يتضمن توحيد الربوبية وليس العكس، ولذلك قال تعالى على لسان الرسول الكريم: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين) (الزمر:11)، ولا شك فى أن الإيمان بتوحيد الربوية واجب إلا أنه ليس مناط الإيمان والكفر، وليس مناط التوحيد والشرك وليس بمجرد الإيمان به يكون المرء مخلصا الدين لله، بل لابد من الجمع بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوية تحقيقًا لقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) (الفاتحة:5) فالعبادة له وحده توحيد للألوهية والأستعانة به وحده توحيد الربوية والجمع بينهما هو أصل الإيمان به وحده كما بينتها الآية الكريمة( ).
وقد جمعت بينهما فاتحة الكتاب فى قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) (الفاتحة:5).
ولا تصح صلاة المؤمن إلا بقراءتها فى كل ركعة، وكان الجمع بين هذين الأصلين من فضائل هذه السورة المباركة التى لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا القرآن مثلها، ولما كانت فريضة الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب الجامعة بين هذين الأصلين: “العبادة، والاستعانة”، أو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؛ دل ذلك على أن الله قد فرض علينا أن نعبده ونستعينه، ولا يمكن القول أن أحدهما يكون بديلاً عن الأخر؛ وقد جمع القرآن بين هذين الأصليين (العبادة والاستعانة) فى أكثر من آية قال تعالى فى سورة هود: (فاعبده وتوكل عليه) (هود:123).
وقال نبى الله شعيب: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) (هود:88).
وقال نبى الله ابراهيم والذين معه: (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) (الممتحنة:4)،
وقال سبحانه وتعالى لرسوله الكريم: (كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) (الرعد:30). كما أمر سبحانه بالجمع بينهما فى قوله تعالى: (فاعبده وتوكل عليه) (هود:123).
ولا شك أن الأمر له هو أمر لأمته ولكل من آمن به، وكان الرسول يجمع بينها بقوله فى دعائه فى قيام الليل: «لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى» …إلخ( ).
والناس فى موقفهم من هذين الأصليين على أقسام أربعة:
1-قسم يغلب عليه التأله والاستغراق فى توحيد الإلوهية. يقصد التأله لله ومتابعة الأوامر والنواهى والإخلاص والحب لله، وفى الله ومتابعة الشريعة بأوامرها وزواجرها لكنه قد يكون منقوصا من جهة الاستعانة والتوكل؛ ليتحقق معنى توحيد الربوية، فيكون إما عاجزًا، وإما مفرطًا، وهو مغلوب عليه أما مع عدوه الباطن (هوى النفس) أو عدوه الظاهر فيكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن على ما فاته وهذا، واقع من كثير ممن يرى أنه متبع للشريعة ولكنه لا يرى قضاء الله وقدره، ولا يرى موقع الحكمة مما يصيبه وإن كان حسن المقصد متبعًا للشريعة طالبًا للحق ولكنه غير عارف بالطريق الموصلة إلى ذلك .
2-قسم يغلب الاستغراق فى توحيد الربوبية، فيستعين بالله، ويتوكل على الله، ويظهر الفقر والحاجة والمذلة بين يدى الله، والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات، ولكنه يكون منقوصًا بين جهة العبادة والإخلاص لله، فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله لله، بل يكون قصده نوع سلطان، ومكانة بين الناس، إما سلطان قدرةٍ وتأثيرٍ وكسبٍ شهرةٍ، أو سلطان كشف وإخبار فيكون إما جاهلاً أو ظالمًا لنفسه تاركًا لبعض ما أمر الله به راكبًا لبعض مانهى الله عنه، وهذا واقع بين كثير من المتصوفة الأدعياء الذين يشهدون قدر الله وقضاءه الكونى، ويغفلون عن أوامر الله ونواهيه الشرعية، وما الذى يحبه ويرضاه، وما الذى يكره ويبغضه، ولهذا يكثر بين هؤلاء الأدعياء من يتحلل من الشريعة أو بعضها.
3-قسم معرض عن الأصلين معًا، فلا يؤمن لا بتوحيد الإلوهية ولا بتوحيد الربوية، فلا يعبد الله ولا يستعين بالله ولا يتوكل عليه، ومن هؤلاء من يدين بدين فاسد فيعبد غير الله؛ ويستعين بغيره، كأهل الملل الفاسدة، الذين تحدث عنهم القرآن الكريم بقوله تعــالـــى: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) (النجم:23).
ومنهم أهل الدنيا لا يدينون بدين ما إلا الخضوع لهوى النفس ولسلطان رغباتها وهم الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله: (لهم قلوب لا يفهقون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل) (الأعراف:179).
4-أما القسم الرابع فهم الذين جمعوا بين الأصلين فى سلوك الطريق إلى الله فجمعوا بين العبادة والاستعانة، فأخلصوا الدين لله وأحسنوا التوكل على الله والاستعانة به، وهذا هو منهج إتباعهم الأنبياء والرسل والمخلصين من أبنائهم .
وقد افتتحت سورة فاتحة الكتاب بالحمد لله رب العالمين إشارة إلى الجمع بين اسم الله واسم الرب، لأن اسم الله أحق بالعبادة والله هو الإله المعبود، والرب هو المُربى الخالق الرازق. فهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة والطلب ولهذا يقال: (رب اغفر لي ولوالدي) (نوح:28)، (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)(الأعراف:23)،
ويقال أيضًا: ربى إنى ظلمت نفسى فاغفر لى.
ربنا أغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا فى أمرنا، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ولقد تكرر هذا فى القرآن كثيرًا كما تكرر فى دعاء الرسل أيضًا، فاسم الله يتضمن الإشارة إلى غاية العبد ومصيره، وما خُلق لأجله وهو حسن التعبد لله وحده دون غيره .
والاسم الثانى يتضمن الإشارة إلى: خلق العبد وحفظه وبداية أمره .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن النفوس خلقت بطبعها فقيرة جاهلة تحتاج إلى من تطلب منه الغنى والعلم والاستعانة على ذلك.
ومن هنا كان علم النفوس بحاجتها وفقرها إلى الرب الغنى الخالق المعين أسبق من علمها بحاجتها وبفقرها إلى الإله المعبود( ).
ولهذا كان إقرار النفوس بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم بالله من جهة إلوهيته وعبادته، وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه من جهة الربوبية أكثر من جهة العبادة والإنابة إليه، ولهذا بعثت الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله الواحد المستلزم للإقرار بالربويبة وقد أخذ عنهم القرآن الكريم أنهم مقرون بالربوبية، قال تعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) (الزخرف:87)، وقال تعالى: وإذا مسهم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه وهم مع إقرارهم له بالربوبية عبدوا غيره.
وكثير من علماء الكلام وأرباب الأحوال من الصوفية ينظرون إلى التوحيد من جهد توحيد الربوبية ويستغرقون فيه فى أحوالهم وأذواقهم ومعظم أقوالهم تتعلق بهذا النوع من التوحيد، والله أعلم.
أ.د محمد السيد الجليند
الهوامش:
( ) الرسالة التذمرية ص101، ابن تيمية وقضية التأويل ص 286، ط دار قباء.
( ) مجموع الفتاوى 1/22-38.
( ) منهاج السنة النبوية 2/ 62 ط بولاق، الرسالة الحسنية والسنية مجموعة شيزرات البلالتين ص260. بتحقيق محمد حامد الفقى مجمع الفتاوى 1/27.
( ) رواه البخارى 2/48 (كتاب الصلاة، باب التهجد؛ أبو داود 1/205 (كتاب الصلاة باب قيام الليل).
( ) قاعدة فى معنى المحبة لابن تيمية، عن دقائق التفسير 1/ 177.
المراجع:
1-شذرات البلاتين من كلمات سلفنا الصالحين، تحقيق محمد حامد الفقى.
2-كتاب التوحيد وإخلاص الوجه والعمل لله لابن تيمية، تحقيق محمد السيد الجلنيد ط دار القرآن
3-دقائق التفسير: لابن تيمية، ج1 ،2.
4-مجموع الفتاوى: لابن تيمية ج2،1.
5-شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم.
6-مدراج السالكين لابن القيم: تحقيق م . د/ عبد الحميد مدكور، ط الهيئة المصرية.
7-درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية.